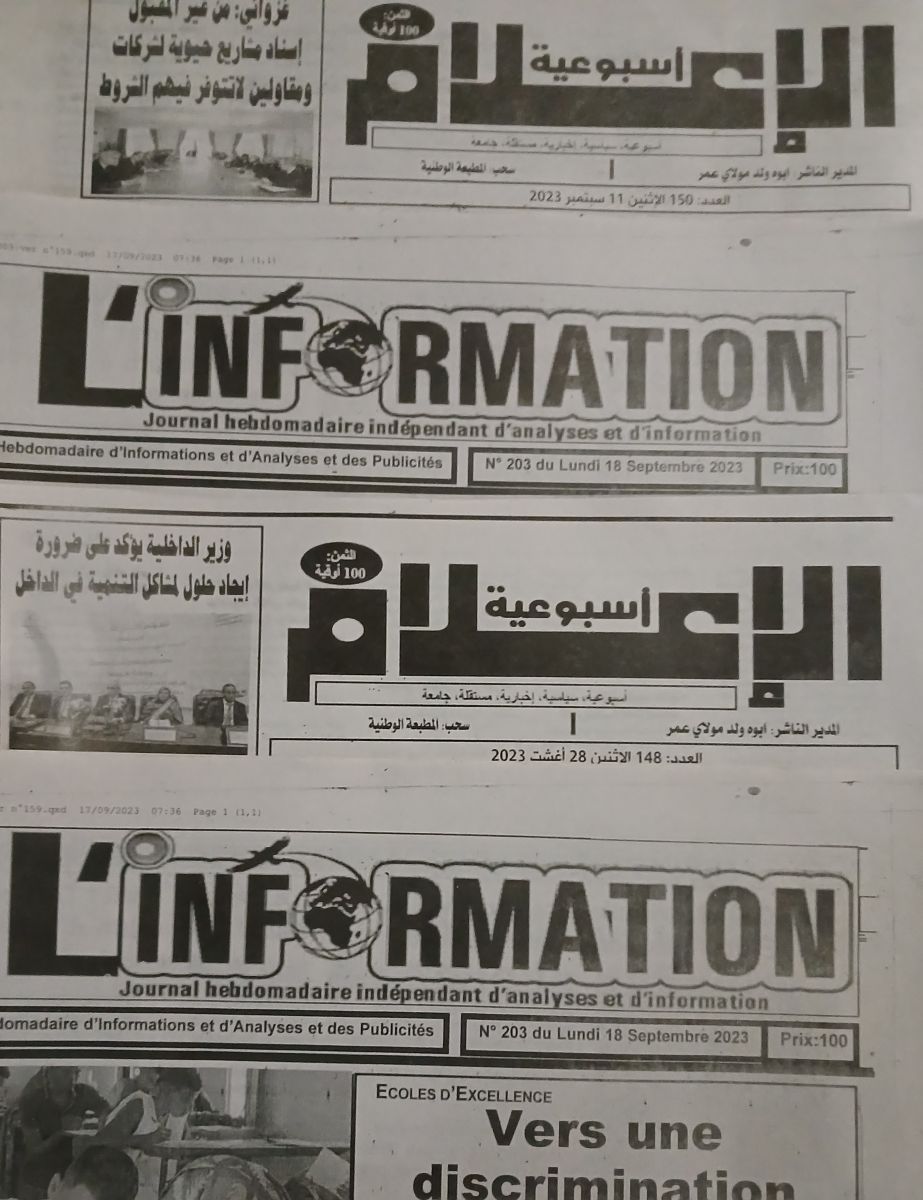لقد دأبت دولتنا منذ سبعينات القرن الماضي على محاربة العلم والتعليم دون هوادة، فألغت المنح المخصصة للتلاميذ في التعليم الإعدادي والثانوي، ثم ما لبثت أن خطت خطوة أخرى أكثر جراءة حين حرمت الطلاب من السكن الداخلي مستقيلة من التكاليف المادية التي يتطلبها النهوض بالإنسان.
وليتها وقفت عند هذا الحد بل أعقبت ذلك بإصدار قانون الإصلاح المشؤوم (وإن تعددت الإصلاحات العقيمة) الذي قسم الشعب إلى شعبين وأحدث أكبر شرخ في اللحمة المجتمعية (تعليم عربي لفئة وآخر فرنسي لفئة أخرى) ومع تدهور التعليم وانحطاطه ازدادت الأمراض الخبيثة وتجذرت في المجتمع ففاضت رائحة العنصرية البغيضة وانتشت الجهوية القبيحة وتعززت القبلية السخيفة لتظل هذه الأمراض العصية تنخر جسم الدولة الفتية.
ومع بداية الثمانينات لجأت الدولة إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات أخرى وتغيير أسمائها في صور فلكلورية واستعراضات عبثية مثيرة للشفقة لتغطية العجز وسوء التخطيط؛ فمثلا تحولت المدرسة الوطنية للإدارة إلى قسم من أقسام الجامعة وتحولت بعض مباني ثانوية البنين إلى المدرسة الوطنية للإدارة بدل بناء وتشييد مؤسسات جديدة استجابة للتطور والنمو الطبيعي للحاجات.
وهكذا تراجعت العملية التربوية بتفقير المدرس وانهيار القيم الأخلاقية تحت وطأة الغلاء المعيشي وفقدان التشجيع وغياب العدالة في الترقيات المهنية وتوزيع المنح الدراسية، كل ذلك ضاعف من معاناة المواطن الذي فقد الثقة في الدولة فبحث عن ذاته في إيقاظ النعرات العرقية الضيقة فانتشر الفساد وساد الخوف من المستقبل واتسع النهب لموارد الدولة وتفشت البغضاء ونمت الكراهية.
وفي العشرية الأولى من الألفية الثالثة سعت الدولة جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة إلى تحويل المدارس إلى أسواق، فالاستثمار لا ينبغي يكون في الإنسان! بعد أن نضب الحياء وجفت القيم ويئس القائمون على العملية التربوية من إصلاحها وتراجعت آمال المواطن في غد أفضل.
غير أن مجيء جائحة "كوفيد 19" كان بمثابة هدية من السماء فوجدت فيه سلطاتنا الراشدة والرشيدة حلا سحريا لتعليمنا المتآكل، فكان الإغلاق ثم الإغلاق ولا شيء غير الإغلاق!!
فهو وحده الكفيل بإزاحة الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الدولة المترنحة وإسكات أصوات من يطمحون ويأملون في إحداث تغيير... فليس للعلم مكان في مجتمعات القهر والفقر.
هذا التدرج الانحداري في المسار التربوي لا يمكن أن يكون صدفة أو اعتباطا بل هو نتيجة لتخطيط محكم وسياسة واعية ومسعى خبيث رسمه قادة ومثقفون لجملة من الغايات والأهداف!!!
ويبقى السؤال المطروح بعد أن جاوز الحزام الطبيين: هل من سبيل لمجتمع تسوده العدالة والمساواة؟ والجواب: هيهات ومع الجهل والفقر تدب نار الفتنة ويزداد الانقسام!!!
.jpg)