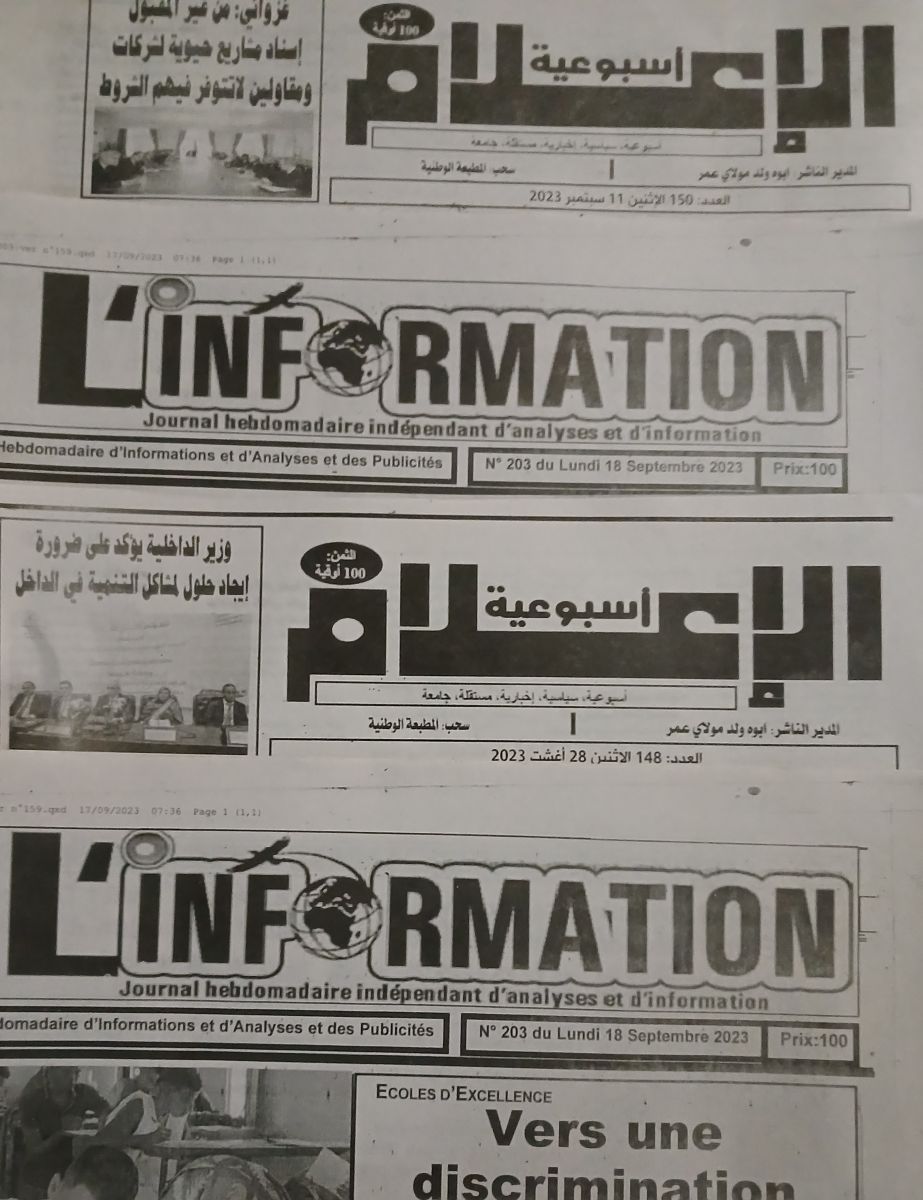ربما يكون وضعنا ليس بالسوء الذي يخيّل إلينا رغم وجع الحياة في موريتانيا وعملية الفرار من أنيابها، إلاَّ أنه حقيقيٌّ بنا أن نتتبع مسار الحاضر، نفتش عنه في ماضينا، لعلنا نجد ما يضيء سراديق المستقبل.
لنعد قليلا للوراء، لبداية الحكاية..
يشكّل يوم 6 اغسطس، علامةً فارقةً في مسار موريتانيا فهو يوم خرق الدستور، ونكسة الديموقراطية المفقودة والتلاعب بقيم الجمهورية، لكن هذا اليوم لم يطوَ بعد، وتداعياته تتمدد وتأخذ مسارات مختلفة ومعقّدة.
في هذا اليوم أطاح الإنقلابي محمد ولد عبد العزيز بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بعد صدور قرار رئاسي بإقالة كل من ولد عبد العزيز، ومحمد الشيخ ولد أحمد الغزواني -الرئيس الحالي- من مناصبهما سبقته مؤامرة سياسية حاكتها القوى العسكرية، تمت من خلالها شيطنة النواب في البرلمان، ليظهر الرئيس في الصورة وحيداً دون موالاة وإهمال الجيش للحدود المعبرية ليظهر عاجزاً عن تسيير البلد.
كان إنقلاباً أبيضا، لم تشبه أي مواجهات عسكرية، سيطر الانقلابيون على القصر الرئاسي بعد ساعات قليلة ليتم الإعلان بعدها عن احتجاز الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الواقف، وتشكيل "مجلس أعلى للدولة" برئاسة قائد الإنقلاب ولد عبد العزيز .
جوبه الإنقلاب حينها بالكثير من الرفض والمقاومة من طرف المعارضة الموريتانية بكافة أطيافها، ليستقيل من المجلس الأعلى الذي تشكل على خلفية انقلابه، وترشّح للإنتخابات الرئاسية بعد أن وقّع مع المعارضة بممثلها حينذاك محمد ولد مولود، على إتفاقية دكار.
لم تعترف المعارضة حينها بالنتائج متمثلة في كلّ من "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" المناهضة للإنقلاب بزعامة مسعود ولد بلخير، وكذلك تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة والذي يتزعمه أحمد ولد داداه، بالإضافة لاستقالة رئيس اللجنة العليا للإنتخابات -وقتها- وامتناعه عن الإعتراف بالنتائج احتجاجا على ما لامسها من لبس واضح في طريقة سريان العملية الإنتخابية وفرز الأصوات. ولأن للأيام قدرة عجائبية على امتصاص هتافات الشارع ونزع ثوب الغضب والحنق عنه، شهدت موريتانيا برمتها، الخامس من اغسطس 2009, تنصيب انقلابي جديد، رئيسا للبلاد.
رغم الإستقطاب السياسي، وتصاعد الإحتجاجات الشعبية الرافضة لحكمه، إلا أنه حظي بولاية رئاسية ثانية، في انتخابات 2014 التي قاطعتها أكبر الأطياف المعارضة الموريتانية.
يحسب للرئيس السابق أنه صنع نظاماً قوياً، وحاضرا في كل البيوت الموريتانية برمزيتان متناقضتان بشكل صارخ، رئيس الفقراء -منقذ دين الله- إلا أنهما يتشاركان في صفة النبوة، فالنبي حافظٌ للدين, وأتباعه في البدايات أراذل الناس ومستضعفيها، لذلك شاهدنا ولد عبد العزيز وهو يفتتح حملاته الإنتخابية من ملعب شعبي بملح، ويكثف زياراته التفقدية -لمآرب سياسية بحتة- للأحياء الفقيرة في وسط " الكبّات" سيزيم سينكيم؛ وعلى الجانب الديني افتتح أول إذاعة قرآنية في البلد، بالإضافة لزيارته غالبية علماء البلد قبيل ترشحه. والحق أن حركة صناعة التاريخ تُغيّرها أحداث عشوائية، لم يكن مقدرٌ حدوثها.
حادثة المحرقة وإعلان بيرام نقطة اللاعودة, بالإضافة لمقال ولد امخيطير حول لمعلمين، كل هذه الأحداث كانت سبيلا لاستمرارية النظام، فقد استطاع إلهاء شعب بكافة أطيافه، ووعدهم بحماية دينهم، ربما هذا التكنيك من أحسن ما جادت به قريحة الجنرال، رغم أنّ أي عملية إلهاء يقوم بها النظام في حق الشعوب المضطهدة، والفاقدة لأسمى ما في الوجود، غاية في السهولة، خاصة إذا تعلق الامر بأشياء لا تحسب بدرجات دنيوية. لذلك نرى أنه رغم حملات الكره والتنفير المتبادل استطاع تشييد حصن متين على نظامه من الثوار العجزة على حد تعبيره، سحب من تحتهم البساط بميكافيلية خبيثة، جاذبا إليه قاعدة شعبية عريضة، كادت في إحدى الأيام مسايرة البلدان العربية في الإطاحة بالأنظمة الرجعية، ليتحول من صراع أرضي إلى ما يمكن تسميّته بصراع سماوي، من المطالبة بإسقاط النظام " گيم گيم" إلى المطالبة بإعدام كل من بيرام و ولد امخيطير.
كما أن الحراك المطالب حينها بإسقاط النظام "25 فبراير" تعرض لخيانة غير مسبوقة من طرف كبار أوجه المعارضة التقليدية، والشعب الموريتاني الهائم على وجهه عرضة للإستحمار على قول علي شريعتي، كما أنه رغم أهميته -الحراك- في تاريخ نضالات هذا الشعب، إلا أنه لم يكن قويا بما يكفي على المستوى التنظيري، فأقدمت على العملي دون النظري، وهذا ليس تنقيصا من مجهودات الشباب، إلا أنه فشل في تحقيق مسعاه، وهذا مردّه أن الاطاحة بنظام متماسك وقوي، غالبا ما يستوجب وجود تنظيم يماثله قوة وتماسكا.
اتسمت فترة ولد عبد العزيز، بنسمة حرية مقارنة بخلفه، مع تحفظي على أنه كأي إنقلابي رجعي، مارس أنواعاً متعددة من الحيف السياسي تجاه خصومه، وعندما شعر بالمضايقة شطب مجلس الشيوخ من المؤسسات الدستورية، زيادة على سعيه الحثيث للحصول على مأمورية ثالثة، قبل أن يتدخل الشارع ويرغمه على إصدار بيان رافض للبقاء في السلطة بعد إكمال ولايتين.
ولأن انتقال السلطة في موريتانيا لا يحدث إلا بطريقتين لا ثالث لهما. انقلاب أو توريث، رشّح رفيق دربه، ومعاونه في الإطاحة بنظام ولد شيخ عبد الله الجنرال محمد الشيخ ولد أحمد غزواني.
حظى بمأمورية رئاسية من خمس سنوات، كأي مرشح للقوى البرجوازية الرجعية. ولم يكن هذا الترشح مفاجئا بالمرة، إذ أنه كان يسير قدما نحو الرئاسة، رغم أنه لم يمارس السياسة من قبل، ولم يكن إلا عسكريا خالصاً. لكنها العقلية الإفريقية، العسكر هو الجهاز الوحيد القادر على إرساء الديموقراطية، والعدالة الاجتماعية، وهذه فكرة قد أثبت التاريخ اختلالها، فالعسكري مهمته خوض الحروب لا ممارسة السياسة.
لكن من عساه يهتم؟ دعونا نقترب قليلا من الحاضر، لنلقي نظرة على هذه السنين الخمسة المشرفة على الانتهاء.
وصل غزواني بمشروع انتخابي معقول على الورق، وخطابات ديماغوجية بإمتياز كوعوده لمواطنيه "بالمشوي" في الوقت الذي يجول فيه الواحد شرقا ويصول غربا بحثا عن عمل يسد منه الرمق دون جدوى، إذ أن عملية البحث عن عمل دون وساطة أشبه بالبحث عن إبرة في المحيط الأطلسي.
استعاد الانقلابي ولد غزواني سياسة الديكتاتور معاوية، التي كانت تعتمد على شيوخ القبائل، أو أفرادها المتنفذين، إذ أنه يحفظ مكانته في قلوب القبائل لا قلوب الضعفاء والمساكين، وهذا بحد ذاته انتكاسة فظيعة، وتركيب واقع سابق لحاضر قائم مُستحدثًا سياقات منقضية لم يبقَ منها سوى الغناء على أطلالها أو البكاء على انتكاساتها، وسبب ذلك العجز عن التحليل أو عدم قدرة على قراءة الواقع أو أنه ما زال عالقًا في أزمانٍ غابرة انقضت، هناك منتصفَ التسعينيات أو في محاولة بائسة لإيهام الناس في صدق مواقفه.
مع أن الفاعل الذي لم يخاطر بأي شيء خلال مساره العام ليس خليقا بثقة أحد، إلا أنّ معارضي عشرية ولد عبد العزيز، وهنا أعني الأوجه البارزة، اختلفوا حول الرئيس الجديد، فمنهم من رآه فرصة للتغيير والتحق بركبه عند بداية الأمر، كأن معارضته للنظام السابق لم تكن سوى معارضة لشخص ولد عبد العزيز وآخرون بطرق خبيثة تحالفوا مع ولد عبد العزيز بعد حرب المرجعية التي خاضها ضد رفيق دربه وهذه ليست إلا حربا بين الرجعيين أما البقية فقد خانوا بالوثيقة المشؤومة، بعد أربع حجج من التطبيع نظرا لاعتبارات سياسية.
قد يقول أحدهم، أن ما فعل غزواني بمثابة موت معلن للمعارضة التقليدية، وهذا ربما حقيقي لحد ما، فالرغم من أن عزير أضرم النار، وخاض حربا شاملة ضد المعارضة بكل أطيافها السياسية، إلا أن غزواني هو الذي أجهز عليها دون حرب وكما جرى العرف، بأن الطبيعة تكره الفراغ، ظهرت وجوه جديدة، ثورية مثوّرة، بدون تنظيم حقيقي لا تعدو كونها مجرد ردة فعل على حالة الاستفزاز والقلق السياسي المتفشية.
"قد ترتدي ثورات التحرر ثوبا دينيا" أو ثوبا آخر المهم أن تظل هناك مقاومة فعلية بالإضافة إلى أنها تمثّل القطيعة دون لبس مع النظام، فضلا عن كونها تعكس الغالبية الإجتماعية التي تراقب بصمت مخيف. قرأت في الفترة الماضية أن ما يحدث الآن، موجة من السوداوية وغياب للتنظير الجاد.
لم تكن تعرية النظام يوما وتتبع عهره السياسي فعلٌ سوداوي ونظرة تشاؤم إلا إذا كانت تنطوي على مسحة من الرياء، لكنه قد يكون غير مؤسس، كأن تطلق السهم دون اهتمام بمكان سقوطه، وهذا بالفعل هو ما يحدث الآن في ظل غياب الثقافة كأداة للثورة، ورفض المثقفين في تبنيها، ليجد المكتوون بجمرة اللاعدل أنفسهم أمام المواجهة، وهذه هي الصخرة التي ستتحطم عليها أي محاولة تغيير جذري.
كما أنني ألفت انتباهكم إلى أن سياسات التجهيل التي ينتهجها هذا النظام-و الأنظمة التي سبقته- هي المسؤولة عن جعل الإنسان المتعلم خادما للسلطة لا للحقيقة، مثقفاً أنذل من الساسة أو -و هذه هي الأكثر شيوعاً- غير مهتم بالسياسية من الأساس، وصفت بريخت "الأميّ سياساً" بأنه غير مكترث بأن الطحين في بيته تحكمه السياسة، جبان وخائن كما وصفه فرانز فانون لأنه اكتفى بأن يكون متفرجا أثناء المعارك الوجودية زيادة على ذلك سياسات المراكمة عبر الحرمان، التي تحدث من خلال مراكمة المال في جانب ثلة قليلة من محتكري السلطة والقوة الغاشمة، ليتراكم البؤس والشقاء في الجانب الآخر المحتشد بالأغلبية الساحقة.
لذلك نجد أننا بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى لمعارضة قوية بتنظيم تقدمي و عمل ثوري، لا يهادن ولا يقبل التنازل ولا التراجع دون الإطاحة بالنظام العسكري الذي أثقل كاهل البلد، بحاجة ماسة لمعارضة تكشف لهذا النظام أنه مهما حدث، ومهما تأخرت لحظة سقوطه فإنه ساقطٌ أولاً في أذهان الناس بسبب السخط الشعبي العارم فتلك أول خطوة نحو سقوطه الفعلي، فالطغاة حسب محمد الماغوط كالأرقام القياسية لا بد أن تسقط في يوم من الأيام.
إن الطريقة التي تتحكم بها هذه الاوليغارشية العسكرية، تؤدي إلى التأثير على الطريقة التي نفكر بها، التي نعيش بها، تحول حياتنا إلى جحيم لا يطاق، ليس لأنها تكتم نفس الواحد فقط، بل تتخطى إلى ما هوّ أدهى من ذلك، فهي تشوّه تصوراتنا كليا حول ما يستحق الإنسان أن يعيشه، تحوّلنا جميعاً إلى أيتام من حيث الضمير و الإنسانية، تجرّدنا من الأخلاق الكونية و الروحانيّة، فساءت الأخلاق و أصبح انتشار الظلم والحرمان عادياً، و جميع أشكال الرذائل كالكذب والنفاق والسرقة والقتل مخلّفين بذلك مجتمعاً من المرضى النفسيين، و لعليّ لا أكذب و لا أقع في المبالغة حين أقول بأن موريتانيا تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى أكبر مصحة نفسية في العالم.
هذا الإستبداد المنمّق باللطافة والأخلاق الذي يصاحبه قهرٌ مجتمعي وتطرف ديني، لا يسقط إلا بانتفاضة الذين لايملكون ما يخسرونه غير قيودهم على قول ماركس، لكن مالسبيل إلى ذلك؟ يروى أن عبد الخالق محجوب حين وقف على مقصلة الإعدام سألوه ماذا قدمت للشعب السوداني و أنت ستموت على أية حال، فقال جملته الشهيرة "الوعي ما استطعت" الوعي الشعبي الذي لن ينتشر إلا بالعمل السياسي و الفكري الجاد و الدؤوب و طويل النفس.
هذا النطام لا يقدر ولو بعد مئات السنين على أية عملية إصلاحية، قد يحقق أشياء خاصة لا يعوّل عليها، لأن الخطأ الذي تعرّض له هذا البلد ليس خطأً خاصا بل خطأ عاما، وهذا يحتاج لزعيم جريئ وفي عجلة من أمره.
و ببساطة يستطيع القاصي قبل الداني إدراك أن ما ذُكر أعلاه ليست بصفات رئيس يهاب شعبه، رئيس يختار النوم خارج المشهد بدل إحراز تقدّم ولو خفيف لهذا البلد.
نرى أنّ هذا النظام البوليسي ليس إلا نسخة سيئة من الأنظمة الرجعية، كل ما قام به حتى الآن هو تدمير الممارسة الديموقراطية والمكتسبات المدنية، والسعي إلى تحويل هذا البلد إلى أغلال معتّقة لا يعترف بالأصوات الناقدة ويسعى بجهد جهيد لاختطافها.
نظامٌ فاشل، سَجن المجنون قبل العاقل، قتل معارضيه في مخافر الشرطة، ورمى المتظاهرين بالرصاص، جعل من نفسه رمزا ذا قدسية و أبّهة و مكانة عالية، رفع الحصانة عن نائب في البرلمان، بتهمة الاساءة للذات الغزوانية، نظام استبدادي، يُصرّ على المضي قدما في هذا العقد المبرم بين الشعب والسلطة، عقد تبادل الذل بفتات الحقوق.
نظام يخاطبنا بغطرسة واضحة "أنتم أيها الشعب المسحوق تُستعبدون في مؤسسات ومصانع وموارد لدولة-سرقت منكم منذ عام 78- حولناها إلى ثكنة خاصة اسمها " موريتانيا العسكر" مقابل أن نؤّمِن لكم موتا بطيئا بدون ضجيج.
فهل يتحرر الموريتاني من مخاوفه ليحرر وطنه؟ أم أنه تقبّل كل هذا الزيف كحالة طبيعية؟
محمد فال عبد العزيز
.jpg)