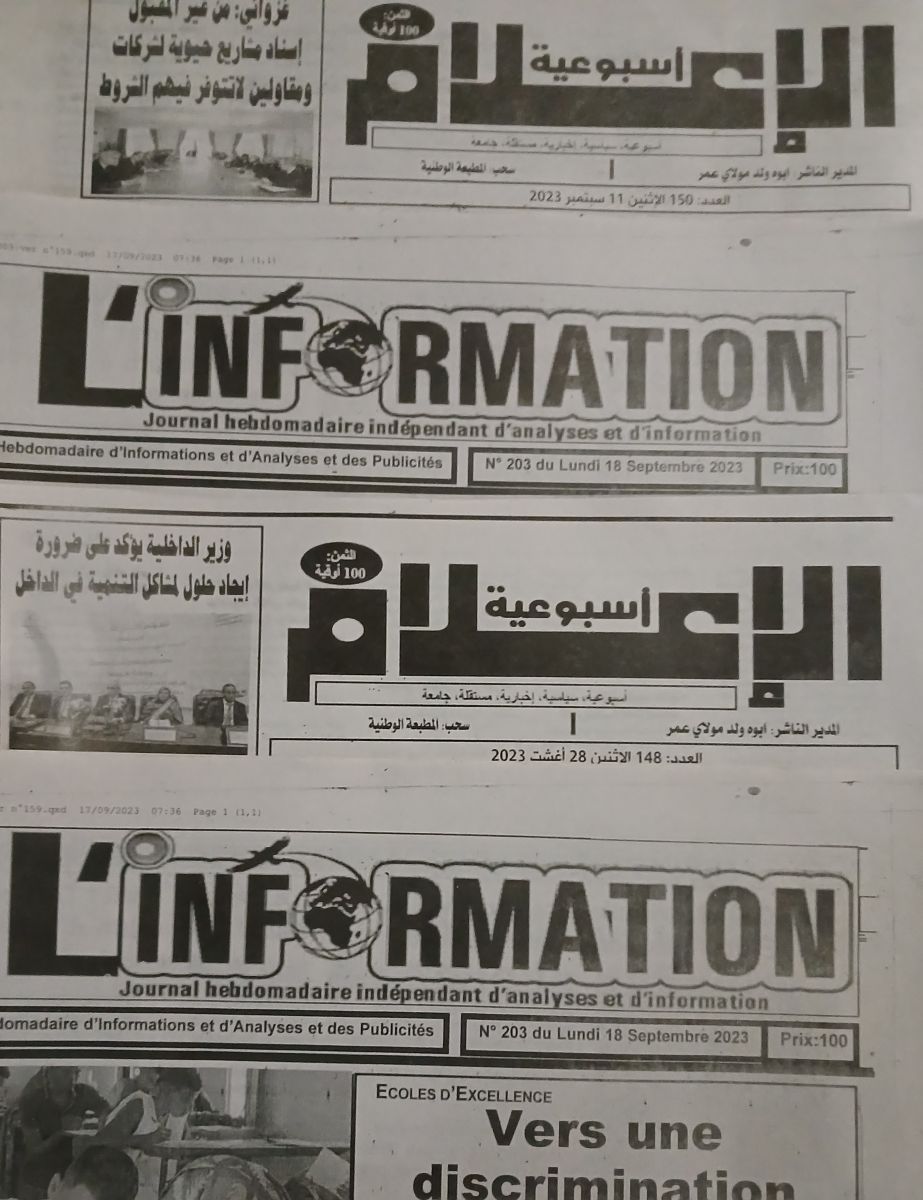أخصائيو علم التاريخ وحدهم مؤهلون لتعليل وتفسير وتمحيص الأحداث السياسية على اختلافها، إلا أن ذلك لا يمنع "الهواة" من الإدلاء بدلائهم قراءة وشرحا وتأويلا لهذه الأحداث. وفي هذا الإطار، أعتقد أنه يمكن -باختصار شديد- تقسيم تاريخنا السياسي الحديث إلى حقب رئيسية.
هناك حقبة "التأسيس" على يد المرحوم المختار ولد داداه التي تميزت بمحاولات جادة لاستنبات "عقل الدولة الموحدة والعصرية" في بيئة متعددة المشارب والولاءات... لقد قصمت موجة الجفاف الماحق -إضافة إلى مغامرة "حرب الصحراء" غير المحسوبة- ظهر الدينامية الواعدة لحقبة "التأسيس" تلك...
تعرفت على هذه الحقبة من داخل أقسام المدرسة الجمهورية، وأود هنا التعبير عن تقديري وامتناني لنظام وفر لي -ولكثيرين آخرين- أسباب التعلم والتكوين، دون ظلم أو تمييز أو منٍّ( سياسي)...
أما الحقبة الثانية فهي الحقبة "الاستثنائية" التي دشنها انقلاب يوليو ١٩٧٨ بقيادة المرحوم المصطفى ولد محمد السالك وتواصلت برئاسة المرحوم محمد محمود ولد أحمد لولي لأشهر قليلة وانتهت بفترة حكم الرئيس محمد خونه ولد هيداله (شفاه الله ورعاه). وتميزت هذه الحقبة بالاضطراب المؤسسي الحاد وتراجع عقل الدولة بشكل لافت، فتنامت النعرات القبلية والشرائحية والعرقية والفئوية والجهوية، في ما بدا وكأنه ردة فعل على محاولات التطوير المجتمعاتي الأولى، إلا أن قطاع التعليم لم تطله يد العبث لأسباب أجهلها. ومن الإنصاف -وكدليل على ما سبق- أن أذكر هنا أنني واصلت مشواري التعليمي بمساعدة الدولة الموريتانية ونجحت لاحقا في مسابقات وامتحانات وطنية هامة، دون أي شكل من أشكال الغش أو الوساطة، كما حصلت على أفضل منحة للدراسة في الخارج فضلا من الله تعالى وبناء على نتائجي التربوية وحدها...
أما الحقبة الثالثة والتي بدأت مع انقلاب ١٩٨٤ بقيادة الرئيس معاوية ولد سيدأحمد الطائع (حفظه الله)، فيمكن اعتبارها "مرحلة الفساد الممنهج"،؛ ولا أعني الفساد المالي أوالإداري فحسب، بل أقصد "أبو الفساد" أي الفساد التربوي... لقد تميزت هذه الحقبة بظهور قاموس لغوي رديء تضمن، من بين مفردات مشؤومة أخرى، مفاهيم "اتلحليح" و"الگزره" و"التبتيب" ومرادفاتها التربوية؛ "الغش في الامتحانات" و"تسمين النتائج التربوية" و"تزوير الشهادات". لقد لاحظت، وأنا طالب في الخارج، منتصف ثمانينيات القرن الماضي، توافد ممنوحين جدد كنا جميعا نعرف مساراتهم المدرسية المتواضعة والمبررات غير الموضوعية وغير العادلة لمنحهم على حساب أصحاب الاستحقاق ؛ فتفشت، بعد قدومهم، ظاهرة الرسوب في صفوف الطلبة الموريتانيين وفقدت شهادة الباكالوريا الموريتانية -لأول مرة- معادلتها لمثيلاتها في دول وازنة علميا وتكنولوجيا...
أما الحقبة الرابعة فيمكن اعتبارها "حقبة رمادية" اضطر خلالها النظام القائم على تبني مسودة دستور للبلاد، في إطار تحول جيوسياسي عالمي كبير وتحت ضغط خارجي قوي ومباشر. إلا أنها بقيت "مسودة" من منظور الحكامة العمومية الفعلية، بل زادت الوضع سوءا، حيثكان على النظام استرضاء طيف تقليدي وسياسي عريض للتغطية على "الغش الانتخابي"، فتعلم شعبنا "الديمقراطية" في مدرسة التزوير المكشوف على أكثر من صعيد... لقد راجت تجارة "العشائرية" و"الشرائحية" و"الفئوية" و"الجهوية" إلى حد أصبح فيه جزء كبير من المناصب الاستراتيجية في الدولة حكرا على “القواعد" وعيا وتكوينا وفكرا... وأود هنا الإشارة إلى أن هذا النظام، ورغم معارضتي له، لم يمانع -كما كان بمقدوره- في اكتتابي في سلك التعليم العالي.
تحت ضغط عوامل منها استباحة البلاد من طرف الجماعات المتشددة في شبه المنطقة وتغول الفساد إلى حد شلل الدولة، دقت المحاولة الانقلابية الفاشلة على "النظام الديمقراطي"، سنة ٣..٢، ناقوس خطر أقنع أوساط حاكمة وازنة بحتمية "التغيير" الاستباقي، إنقاذا لهذا الأخير من انهيار شامل وشيك.
لقد عشت هذه الفترة كأستاذ للتعليم العالي وكمعارض سياسي، حيث واكبت "تحورات" قطب المعارضة الرئيسي في البلاد بدءا ب-"افديك" ومرورا ب-"إي اف دي” و "إي اف دي-أير نوفل" ثم "إي دى بي" وانتهاء ب-"التكتل"...
ودون تعميم غير مبرر، فقد انتشرت عدوى الفساد التربوي داخل تعليمنا العالي الوليد، ومن تجليات ذلك ولوج البعض ل-"الأستاذية" دون مؤهلات آكادمية دنيا، نتيجة للفساد الإداري المستشري وتزوير الشهادات الذي تفاقم في هذه الفترة بسبب التساهل المشين فيما يتعلق بمعادلة ...الشهادات، على وجه الخصوص. لقد كان بوسع البلاد أن تحمي هذا القطاع الناشئ من الفوضوية، خاصة أن ولوجه يخضع لشروط علمية واضحة ومتعارف عليها عالميا، كما كان باستطاعتها جلب طواقم تدريسية من الخارج ريثما يتم تكوين أساتذة موريتانيين بالمعيارية والمهنية المطلوبتين. وعلى إثر عجزها عن ذلك، حدث نوع من الهجرة "القطاعية" للأدمغة على حساب التعليم العالي. لقد كنت شاهدا على ممارسات ومسلكيات مخجلة تستغرق كتابا كاملا؛ فمثلا خلال إشراف، نهاية التسعينيات الماضية، على امتحان الباكالوريا في "ثانوية توجنين"، لاحظت أنني كنت أحوج إلى "رقابة بعض المراقبين" من رقابة التلاميذ... الشيء الذي دفعني -على مضض- إلى اعتزال "الإشراف الطوعي" على هذا الامتحان الوطني الهام.
لم يتفاجأ الكثيرون داخليا وخارجيا بانقلاب ٥..٢، نظرا للأوضاع الصعبة (على أكثر من صعيد) التي كانت تمر بها البلاد، هذا الانقلاب الذي أوصل المرحوم اعلي ولد محمد فال إلى كرسي رئاسة الدولة؛ ولا يزال هناك جدل إلى اليوم حول العقل المدبر الحقيقي لهذا الانقلاب، إذ يجزم الكثيرون على أنه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (حفظه الله). وعلى إثر "ثورة القصر هذه"، عاشت البلاد مرحلة انتقالية اتسمت" بحوار الصم" بين، من جهة، جناح سياسي متماسك نسبيا كان هدفه الأول الإبقاء على النظام بعد أن تم التخلص من رأسه، و إجراء بعض "الرتوشات" المؤسسية، ومن جهة ثانية، جناح آخر (متنوع) كانت القطيعة مع هذا النظام تكاد تكون عنصر التلاقي الوحيد بين مكوناته... بعد أكثر من لقاء وأكثر من تردد، تقرر في النهاية إجراء انتخابات بلدية ونيابية أولا، واستحقاقات رئاسية بعد ذلك بقليل.
يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية سنة ٧..٢ -وقبلها البلدية والنيابية ٦..٢- بداية لحقبة جديدة ( خامسة) في بلادنا، حيث استطاعت القوى الديمقراطية فرض معادلة سياسية استوجبت، لأول مرة في تاريخنا الانتخابي، اللجوء إلى شوط ثان لحسم استحقاق رئاسي. لقد طلب مني "التكتل" (٦..٢) الدفاع عن أول لائحة انتخابية له -على الإطلاق- في مقاطعة باسكنو النائية، فقبلت الترشح (التحدي) الذي تحول إلى كارثة انتخابية كما كان متوقعا (فقط ثلاثة مستشارين بلديين ونسبة من رقم واحد لصالحي في النيابيات!). لقد اعتبرت وقتها أن ضيق الوقت وعدم معرفة مسبقة بهذه الدائرة الانتخابية (رغم وجود حدود مشتركة بين منطقتي "كوش" و”تلمسي"!) وشح الوسائل المادية، شكلت أهم مبررات هذه الكبوة المؤلمة ؛ إلا أن عزائي في كل ما حدث كان الهدف التاكتيكي من وراء تغطية البلاد بترشحات بعضها مرتجل، هدف التحضير المحكم للاستحقاقات الرئاسية الموالية...
وعلى الرغم من مرارة هذه التجربة على الصعيد السياسي، إلا أنها علمتني الكثير من الدروس المفيدة، واحتفظت بذكريات جميلة بخصوصها ؛ منها "التنفيس المعنوي" الذي خصني به أحد ساسة البلاد الكبار، عندما وصف ترشحي في باسكنو ب-:
“ !Une candidature de témoignage“
أي "ترشح للشهادة!"... كما أذكر تلك الليلة الباردة في "تنواگتين" عاصمة بلدية "المگفه"، غير بعيد من حدود دولة مالي الشقيقة (!)، حين أخذت الكلام أمام جمهور معتبر، بعد الاستماع إلى نغمات سحرية للفنانة الكبيرة (حفظها الله) المعلومه بنت الميداح ("امعارضين! امعارضين!"...)، فارتأى أحد مضيفينا أن يحيينا على طريقته الخاصة، فرفع مدفع "كالاشنيكوف" خلفي مباشرة ودون علمي، وأطلق وابلا من العيارات النارية في سماء الليلة المظلمة ؛ لقد أصبت بفزع حياتي! إلا أنني حاولت أن أتماسك ما استطعت، خوفا من أن يُشاع في هذه المنطقة المعروفة بشجاعة أهلها الأسطورية أن "أهل التكتل ما هم ارجال حته"!... لقد لا حظت، بعد أن اتضحت ملابسات الحادث وانتظمت دقات القلب وتحررت التعاليق، أن "الشرف تم صونه!"...
لم يعاقبني "التكتل" على هذا "الإخفاق الانتخابي"، بل تم تعييني أحد المدراء المركزيين للحملة الرئاسية (٧..٢) للمرشح أحمد ولد داداه(حفظه الله) ؛ وبوسعي أن أقول هنا إنه، ورغم الدعم الرسمي المعلن للمرحوم سيدي ولد الشيخ عبدالله، فقد نجحت النخبة المتعلمة الموريتانية في تمرير خطاب واضح بضرورة دمقرطة الحكم في البلاد وإصلاحه وترشيده... بعد هذه الانتخابات مباشرة، شرفني الرئيس أحمد ولد داداه بتعييني ضمن لجنة رباعية للتفكير حول إعادة هيكلة الحزب وتنشيطه، إلا أن مشاغل مهنية ضاغطة حالت دون مواصلة مشاركتي في أعمال هذه اللجنة.
لم يعمر -مع الأسف- أول حكم ديمقراطي موريتاني طويلا، لسبب بسيط هو أن "مخططيه" الأوائل لم يناقشوا "ما-بعد-النجاح" الرئاسي في التفاصيل وبالجدية الكافية، كما ساهم، يومها، "شركاء جدد" متمرسون في فن المناورات التفخيخية (كانوا قد قدموا لتوهم من صفوف المعارضة) في زعزعة الوضع السياسي ... وعلى الرغم من أنني كنت معارضا لهذا النظام، إلا أن المرحوم سيدي ولد الشيخ عبدالله فاجأني بعدله عندما أمر -عكسا لما نصحه به جل فريقه الحكومي ومستشاروه ولِما كنت أتوقعه شخصيا- باحترام نتائج أول (وآخر!) مسابقة حسب المعايير العالمية لرئاسة جامعة نواكشوط، فشغلت هذا المنصب وأنا ناشط في صفوف المعارضة. وبمساعدة فريق جامعي مقتدر وعلى الرغممن تحديات اعتماد نظام “ل-م-د" وتخفيض "تعجيزي" للميزانية من مليار وأربع مئة مليون أوقية إلى خمس مئة وثلاثة وعشرين ملونا فقط، تم إدخال إصلاحات جوهرية على مؤسسة جامعة نواكشوط، بعد تنظيم ثمان ورشات تشاورية متخصصة، أذكر على سبيل المثال لا الحصر: انتخاب العمداء ومختلف المجالس طبقا للأعراف الجامعية، إيقاف الولوج الفوضوي "للأستاذية" و اعتماد لوائح (استحقاقية) تأهيلية للمتعاونين...
فتح انقلاب ٨..٢ باب حقبة سادسة، أعادت رسم خريطة البلاد السياسية، حيث تشكلت جبهة وازنة ضد الانقلاب بينما اعتبر زعيم "التكتل" أحمد ولد داداه أن الأمر يتعلق بحركة "تصحيحية" ؛ وبعد نقاش مستفيض داخل هذا الحزب الكبير، تقرر ديمقراطيا دعم الانقلاب. لقد بذلتُكل الجهود الممكنة لتجسيد هذا الخيار، فعلى سبيل المثال، شاركت في مسيرة راجلة ضخمة صوب القصر الرئاسي والتقيت، على انفراد ولأول مرة، بقائد الانقلاب (وقتها) الجنرال محمد ولد عبد العزيز. بعد احتدام الصراع السياسي مع خصم عنيد، قرر زعيم "التكتل" التراجع عن دعمه للانقلاب لأسباب أجهلها، إلا أنني ومجموعة من الأطر قررنا مواصلة هذا الدعم نظرا للبرنامج الإصلاحي الذي أعلن عنه قادة الانقلاب ولحجم الجهود التي كنا قد بذلناها، حيث كان من الصعب أو شبه المستحيل علي شخصيا الانخراط مباشرة في نقيض ما انهمكت فيه بكل ما أوتيت من جهد وتسليم نفسي لخصم سياسي كنت أقارعه منذ ساعة أو أقل ؛ لقد خانتني وقتها المسوغات الفكرية والمنطقية قبل مقتضيات التكييف السياسي، كما لم يسعفني الوقت... فما هي يا ترى مصداقية خطاب تختلط أصداؤه بأصداء نقيضه الحديث في آذان الرأي العام وعلى نفس اللسان؟!... في تقديري أن هذا التراجع المفاجئ من طرف هذا الحزب العريق هز قواعده وأثر عليه سلبا لاحقا. وددت لو أبقى الحزب على قراره الأول وأبدى المرونة اللازمة ولو مرحليا، على غرار ما قام به زعماء سياسيون مثل "افرانصوا ميترانه" و "عبدالله واد"...
فلو شاءت الأقدار أن تمسك "التكتل" بموقفه الأول تجاه انقلاب ٨..٢، لكانت البلاد قد جنت ثمرة ذلك الموقف التاريخي، ولكانت اليوم في وضعية أفضل بكثير (وهذا هو المهم!) مما هي عليه، خاصة من المنظور السياسي...
.jpg)